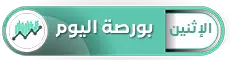من شرم الشيخ إلى دافوس: توازنات جديدة… وفرص لا تُمنح مرتين
في يوم 1 فبراير، 2026 | بتوقيت 12:45 م

كتب: العالم اليوم
تشهد المنطقة في هذه المرحلة لحظة فارقة من إعادة التشكّل، في ظل تطورات ملف غزة، وما أفرزه اتفاق شرم الشيخ من توازنات جديدة، ثم ما ظهر بوضوح في كواليس ما قبل وأثناء منتدى دافوس من إعادة ترتيب اصطفافات وتحالفات.
هذه التطورات لا تعبّر عن إدارة أزمة عابرة، بقدر ما تعكس تحوّلًا أعمق في قواعد النفوذ الإقليمي، حيث لم تعد القوة وحدها معيار التأثير، بل أصبحت القدرة على الإدارة، وضبط الإيقاع، وقراءة المصالح المتقاطعة هي العامل الحاسم
في هذا السياق، تبرز مصر كأحد أهم اللاعبين في هذه المرحلة، ليس فقط بحكم موقعها الجغرافي أو ثقلها التاريخي، بل بحكم الأداء السياسي الرصين للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارة واحد من أكثر الملفات تعقيدًا في المنطقة.
إدارة ملف غزة اتسمت بالهدوء، والواقعية، والابتعاد عن الانفعال، مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي، وهو ما أعاد تثبيت موقع الدولة المصرية كوسيط موثوق وقوة توازن لا يمكن تجاوزها في أي معادلة إقليمية قادمة.
على مستوى الدولة، تفتح هذه المرحلة أمام مصر فرصًا سياسية واستراتيجية حقيقية، سواء في إعادة تعريف دورها الإقليمي، أو في تعزيز موقعها داخل منظومة التحالفات الدولية.
فالعالم اليوم لا يبحث فقط عن دول ذات خطاب قوي، بل عن دول قادرة على إدارة الأزمات، والتواصل مع أطراف متناقضة، وتحقيق قدر من الاستقرار في بيئة شديدة الاضطراب وهي سمات باتت واضحة في الأداء المصري خلال الفترة الأخيرة.
غير أن هذه الفرص السياسية، مهما بلغت أهميتها، لا تتحول تلقائيًا إلى مكاسب مستدامة يشعر بها المواطن المصري ما لم تجد طريقها إلى الاقتصاد الحقيقي، وإلى قدرة الشركات الوطنية على التحرك بمرونة داخل هذه التحولات المتسارعة.
على مستوى الاقتصاد الكلي والشركات المصرية، تتيح المرحلة الجديدة فرصًا واسعة في مجالات إعادة الإعمار، وسلاسل الإمداد، والتوسع الإقليمي، وبناء شراكات عابرة للحدود.
لكن اقتناص هذه الفرص لا يعتمد فقط على توافر رأس المال أو العلاقات، بل يتطلب قبل كل شيء إدارة واعية، واختيارًا دقيقًا للأشخاص، وبناءًا مؤسسيًا قادرًا على استيعاب تعقيدات المرحلة.
وهنا يصبح معيار الكفاءة—لا الولاء والطاعة —هو الفيصل الحقيقي بين من ينجح ومن يتعثر.
من المفيد في هذا السياق استحضار تجربة من الحقبة الناصرية، وهي العلاقة بين الزعيم جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر، ليس كحكم تاريخي أو تقييم سياسي، بل كدرس إداري بالغ الدلالة.
لا يمكن التشكيك في نوايا الرئيس عبد الناصر أو زعامته وكاريزمته الشخصية ، فالإشكالية في جزء من التجربة الناصرية لم تكن في النوايا أو الوطنية أو الشعبية بل في طبيعة العلاقة بين الرجل الأول والرجل الثاني : ثقة مطلقة، مركزية قرار، غياب للمساءلة ..
ومع الوقت، تحولت هذه العلاقة من عنصر دعم إلى نقطة ضعف بنيوية، لأن القرار لم يعد مؤسسيًا، بل شخصيًا، ولم تعد الكفاءة هي معيار النفوذ، بل القرب من مركز اتخاذ القرار. وكانت النتيجة أزمة كبرى لم تنبع من ضعف الإرادة، بل من خلل في الإدارة.
هذا النموذج لا يخص الدول فقط، بل يتكرر اليوم داخل كثير من الشركات، خاصة العائلية منها، حيث يتحول “الرجل الأول” إلى مركز القرار الوحيد، وتتشكل حوله دائرة ضيقة من أهل الثقة، لا بالضرورة من أهل الكفاءة.
في المراحل الأولى، قد ينجح هذا النموذج، بل وقد يمنح سرعة في الحركة وحسمًا في القرار. لكن مع التوسع، ودخول الشركات مراحل أكثر تعقيدًا إقليميًا ودوليًا، يتحول إلى عبء حقيقي يحدّ من القدرة على التكيّف.
الخطر هنا لا يكمن في فقدان الفرص الاقتصادية—فالفرص غالبًا ما تظل قائمة—بل في سوء إدارتها، وفي العجز عن استيعاب حجم التحولات الجديدة التي تتطلب تنوعًا في الخبرات، وجرأة في النقد الداخلي، وفصلًا واضحًا بين العلاقات الشخصية ومنظومة اتخاذ القرار.
تمثل الشركات العائلية عمودًا أساسيًا في الاقتصاد المصري، وتمتلك مزايا حقيقية من حيث المرونة وسرعة القرار. إلا أن بعض هذه الكيانات تعاني مما يمكن وصفه بـ«آفة الثقة المطلقة»، حين تتحول الإدارة إلى دائرة مغلقة، ويُنظر إلى البناء المؤسسي باعتباره ترفًا لا ضرورة.
وفي مرحلة إقليمية تتسم بتغيرات متسارعة، وقواعد جديدة للتجارة والتمويل والشراكات، ومنافسه مع شركات اقليميه تتبع دولا اخري تتبني نماذج اداريه أكثر حداثه ( في العمق الثقافي للشركات وليس فقط في برامج الكومبيوتر باهظه الثمن والملصقات التسويقية ذات الشعارات الرنانة ) يصبح هذا النمط الإداري غير قادر على مواكبة المستجدات، مهما كانت قوة النوايا أو صدق الانتماء.
في المحصلة، يمكن للشركات المصرية أن تكون الحصان الرابح في منطقتنا لاقتناص الفرص الاقتصادية التي تقدمها المرحلة الحالية، إذا توفّرت الإرادة، وتوافرت إدارة حكيمة ترتقي إلى مستوى اللحظة التاريخية التي نمر بها اليوم.
والإدارة الحكيمة لا تعني فقط الخبرة أو حسن النوايا أو البراعة التقنية، بل تعني قبل كل شيء تحرّر الرجل الأول في المؤسسة من احتكار اتخاذ القرار، والتحلّي بتواضع العلماء، والاعتراف بأن البناء المؤسسي المنضبط والحوكمة الرشيدة لم يعودا خيارًا، بل ضرورة حتميه.
والأهم من ذلك، أن تملك المؤسسات الشجاعة لإقصاء كل من يمثّل نموذج «عبد الحكيم عامر» داخلها، واستبداله بفِرق عمل كفؤة ومخلصة، تُمنح الفرصة الحقيقية، وتملك القدرة على أن تقول «لا» حين يكون القرار مهددًا للمستقبل.
فالمرحلة القادمة لا تحتمل المجاملة، لأن ما يلوح في الأفق ليس مجرد فرص عادية، بل فرص لا تُمنح مرتين.